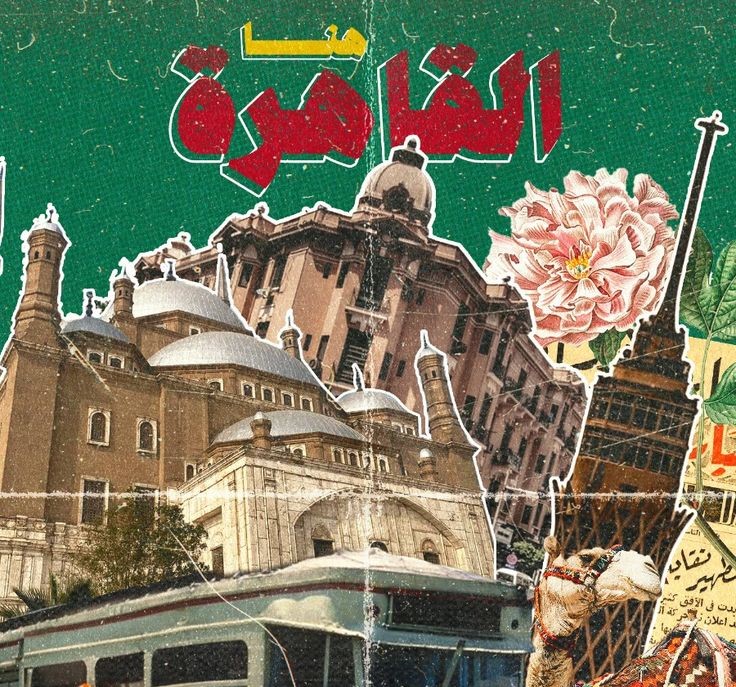اليوم أستطيع أن أعرب عن اعتقادي أنني عشت حياة سعيدة. حياة تخللتها ولا شك أيام تعيسة أو لحظات صعبة أو حزينة أو حرجة، ولكن في جملة المسيرة أو في حصيلة ما مررت به صعودا وانحدارا وبالمقارنة بما علمت عن تجارب في الأهل وبين الأصدقاء ومن اطلعت على سيرهم من المشاهير والعامة وطبقا لمقاييس عديدة يجب أن أسجل أنها كانت سعيدة. ولكن ما دمت أتيت على ذكر التعاسة والحزن والصعوبة والحرج في وصف أيام أو لحظات مرت بي أو عشت فيها أجد من واجبي أن أسجل أيضا أنني لا ألقي على زماني مسئولية أي من هذه الأيام، فزماني كزمان كل الناس كان مجرد شاهد غير منحاز. استضافني لعقود عديدة فكان كريما ووفر لي أهلا طيبين وزوجة متفانية وذرية صالحة. كان سخيا في كرمه.
***
أظن أن سعادتي بدأت مبكرا. أقول أظن لأنني أكتب عن طفل ما يزال في مرحلة الرضاعة. قيل وتردد القول كثيرا أمامي وأنا أكبر سنا ومن مصادر كثيرة ومتنوعة أنني كنت طفلا يسعد إذا تعددت مرضعاته، يعرف كيف يسعى من أجل تحقيق هذا التعدد والمحافظة عليه، وكيف يبادلهن الرضا، وكيف يعبر عن اعترافه بجميلهن. قيل أيضا وتردد القول بأنني كنت من هواة الهواء الطلق خلال الرضاعة. فضلت دائما أن تقع الرضاعة خارج البيت وفي الليل وفي الهواء الطلق. سمعت أيضا عندما كبرت من بعض أهالي أصدقائي أن معظم فترات هدوئي وراحتي ونومي كرضيع كانت تبدأ بمسيرة يتبادل عليها متطوعون من الجنسين تقطع شارعنا ذهابا وإيابا خلال الساعات الأولي من الليل.
***
وقعت في الحب ولم أتجاوز الثامنة من عمري. تعاقد أهلي مع مدرسة في مدرسة إبتدائية على ناصية شارعنا مع شارع خيرت. ساقها إلينا طموح أبي أن يقفز بي سنة دراسية أو أكثر فوق ما يسمح به عمري. نجحت الفكرة وإن تسببت في مشكلة التأقلم مع زملاء في مختلف مراحل التعلم ومشكلة عند التقدم للعمل في وزارة الخارجية. كانت معلمتي رائعة في قدراتها الخاصة بالتعامل مع طفل في الثامنة من عمره ثم وهو في التاسعة. تعلقت بها حسب رواية والدتي لي فيما بعد. تعلقت إلى حد “مرضي” بمعنى الكلمة. قالت إن حرارتي كانت ترتفع إن غابت أبلة “عيشة” لدواعي السفر أو المرض. قيل أيضا إنني كنت أصر على ارتداء أفضل ما عندي وأقف على باب العمارة لاستقبالها عند وصولها. أعترف أنني ما زلت أتذكرها وأتذكر قدر سعادتي في تلك الأيام، أسعد أيام طفولتي.
***
كانت مصر في ذلك الحين في موقع الحليف لبريطانيا العظمى، العلاقة التي جعلتنا هدفا لطائرات ألمانيا النازية. أذكر أنه خلال الغارات وبمجرد إطلاق صفارات الإنذار يوقظنا الأهل ونترك شقق السكنى بعد أن “نلتحف” بالبطاطين أو ملابس ثقيلة موجودة دائما بجانب باب الخروج لننزل بسرعة إلى الطابق الأرضي. هناك ننقسم فريقين، فريق الرجال يدلف إلى شقة على اليمين وفريق النساء يتوجه لشقة على يسار السلم، وعلى الفور ومع طلقات المدافع المضادة للطائرات ينطلق الدعاء وما زلت أذكره بلحنه المميز “يا نبي الألطاف نجنا مما نخاف”. أما الأطفال، وأنا منهم، فيقضون في أحضان الأهل بعض الوقت كل حسب جنسه ليفترقوا بعد قليل عن الأهل ويخرجوا من الشقتين لنلعب على “البسطة” في ظلام الليل الدامس، يزيده ظلمة السد الحجري المشيد على باب العمارة ليحول دون وصول شظايا القنابل إلى الداخل. أذكر أننا كنا نبتكر لعبة جديدة في كل غارة ونغضب بشدة عندما تطلق صفارات الأمان إيذانا بانتهاء الغارة وكذلك نهاية اللعب والسعادة التي ترافقه وإيذانا بضرورة العودة فورا للنوم.
***
لن أنسى بأي حال وتحت أي ظرف ليلة العرس. كنت في الثانية وعشرين وكانت العروس على باب الثامنة عشر. رأيت في نظرات زوجات أكثر من خمسين سفير أجنبي والمئات من السياسيين الهنود نظرات فضول. كان هناك أيضا عشرات من شباب السلك الدبلوماسي. أتذكر أنني أكاد أكون رأيت وأنا أمشي بين المدعوين ومن خلفي يمشي زميلان بزي السهرة خيال أمي التي كانت تحلم بأن تعيش لتراني في كوشة حفل زواج ودعاءها كدعاء أمها لي “ربنا يرزقك يا إبني بالزوجة المطيعة والذرية الصالحة”. أتذكر العروس وقد شعرت بما يدور في ذهني في تلك اللحظة ربما لأنني تعثرت في مشيتي فهمست بكلمات تعني بها أنها تتفهم. وللحق تفهمت وعاشت تتفهم. أمها أيضا ساهمت، تركت ضيوفها واقتربت لتمشي معنا إلى جانبي. ليلتها وطول عمرها كانت نعم النصير.
***
من صفاتي غير الطيبة أنني لم أكن أكشف عن سعادتي وفرحي أمام الناس حتى أقربهم. كان أبي يسعى بعلاقاته لمعرفة نتيجة امتحانات الشهادات قبل أن تباع في عدد خاص لصحيفة يومية يصدر بعد ظهر يوم من أيام الصيف. أحيانا كان يحمل خبر النجاح ويستقل القطار ويأتي به خصيصا إلى سيدي بشر حيث كنا نقضي الصيف أو بعضا منه. كان الفرح من طبيعته وينقله للجميع. أتلقى الخبر السعيد بالرضا وإن لزم الأمر فبالأحضان التي فضلتها دائما كناقلة فرح وسعادة وحب. ذرفت الدمع مرة أخرى وأنا أتلقى شهادة الماجستير في جامعة ماكجيل الكندية لأن أبي الذي اختار نجاحاتي ساحات لأحلامه فاتته هذه الفرصة.
***
صبي وإبنتان وأحفاد سبعة وأولاد الأحفاد ثلاثة هم مصدر سعادة. هؤلاء عشيرتي أسعد لوجودهم في حياتي وأشقى لمتاعبهم إن وجدت. كم تمنيت لو أن زوجتي، أي جدتهم، عاشت لتراهم، كما أراهم، كل يوم جمعة. يومها يحلو لي دائما أن أعود بالذاكرة إلى أيام شقيت، وشقيت هي معي، بسبب شقاوتهم، لتخلف الشقاوة والشقاء معا سعادة لا توصف ولا تنسى.
تنشر بالتزامن مع جريدة الشروق