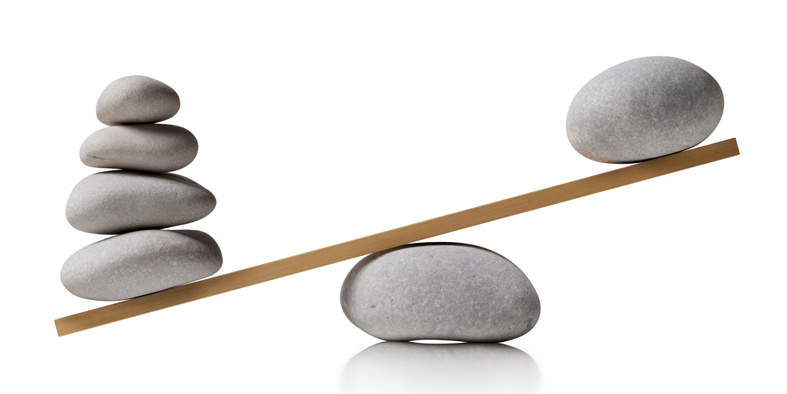نخب تضمر غير ما تظهر. تصعد سفينة الاعتدال الديني وتعتقد أنها بذلك تحمي نفسها من تهمة الإرهاب والتطرّف. وهي تضمر فكراً ملوثاً بالوهابية والتطرف الديني لدرجة أو لأخرى. الانتهازية في موقف هذه النخب هي أنها تحاول إرضاء الغير ممن ليسوا من شعبها بغضّ النظر عما يتطلبه العمل مع شعبها لاكتساب سوية دينية مفقودة. موقفها الديني ينبع من موقف سياسي ينحني أمام الريح من دون أن يغيّر شيئاً ممّا في نفسه. هي عملياً تتخلى عن شعبها وتعلن انفصالها عنه عندما تميّز نفسها بالاعتدال الديني. فكأنّ هناك تطرّفا دينيا غير ما تفرضه الأنظمة العربية، وكأن الأنظمة العربية لم تسع الى نشر التطرّف الديني، بنجاح أو من دون نجاح، حسب القطر العربي المعني. ثم تقدّم أوراقها للغرب على أنها معتدلة، أي ان الأنظمة غير الناس. فمن الواجب دعمها كي تمارس مهامها. وهي في الغالب قائمة على القمع والسرقة والنهب والتعصّب الطائفي. يغيب عن بال الجميع أن كل ممارسة جماعة دينية وهابية أو إيرانية الدافع اليها ممارسة بعيدة عن الاعتدال. تقسّم الناس بين مؤمن وكافر، وتدعو الى هداية المسلمين ذوي الرأي المختلف.
يدعو هؤلاء الى ممارسة دينية باعتدال. أيّ ممارسة دينية؟ لا يقولون. الممارسة الدينية الحقة هي الفردية الإيمانية التي يقودها السعي الى بناء علاقة مباشرة مع الله من دون وسطاء. النخب السائدة، خاصة المأجورة، دعوتها قائمة على توسيع الممارسة الدينية الجماهيرية. وهي تدري، ونشكّ أنها لا تدري، أن كل ممارسة جماعية هي ممارسة سياسية تصب في صالح حكم الطغيان. لم ولن يسمع الطاغية خطبة الجمعة إلا إذا كان المضمون لصالحه. المزاج الديني واسع الانتشار. لكن المشاعر هي في الأساس ضد الطغيان والقسر والإكراه والسجن والتعذيب. لا يستطيع الخطيب ذكر شيء من ذلك وإلا تعرّض هو نفسه. وكل كلام في غير هذا الأمر، في المجال العام، يصب في خانة الطاغية. ولا يستطيع الفقيه أن يصدر كتاباً ليس في مصلحة صاحب الأمر. الرقابة له بالمرصاد. النضال ضد الطغيان يستدعي لغة غير لغة الاعتدال والتطرّف. في هذه اللغة الاختيار مأخوذ سلفاً. هو الاعتدال حتى عند من يستهويهم المناخ الوهابي، عن ايمان أو مصلحة، وغالباً ما تكون المصلحة هي التي تقرر. يلعبون لعبة النظام السياسي العربي، نظام الطغيان. واللعبة تضطرهم الى موقف الاعتدال حتى ولو كان بين الوهابية وخصومها، وبين المرشدية وخصومها، لأن الإثنين يجعلان الدين محور حياة المجتمع، ولا خيار للناس في ذلك. الموقف الديني الذي تعلنه السلطة هو ما يجب أن يتبناه كل الناس. ليس في ذلك اعتدال.
النضال ضد هذه الأنظمة، النضال الذي يتماهي مع مصالح مجتمعنا، إذا كان حقيقة يريد التماهي مع الجماهير، فهو الذي يبحث في دور الدين في المجتمع، لا فقط في الموقف الذي يجب أن يتخذ بين القوى المتناحرة.
لا يستقيم أمر مجتمعنا إلا بالدعوة لتحجيم دور الدين. يدعو الاخوان المسلمون الى أن الإسلام هو الحل، بمعنى أنه الحل لكل الحياة الاجتماعية. وهذا اعتبار مدمّر للمجتمع. الدين وشرائعه لا يتعلّق إلا ببعض مشاكل مجتمعنا. يجب أن يحصر دوره في المسائل الإيمانية، في العلاقة بين الإنسان وربه، وينصرف الناس الى حل مشاكلهم بعقلانية، أي باستخدام العقل والتجربة البشرية، وتجاوز الماضي، وتجاوز السلف الصالح وغير الصالح، والنظر الى المستقبل لتجاوز ما نحن فيه، والدخول في العالم للاندماج في الثقافة العالمية. وهي غربية في الأساس.
يتهرّب الكثيرون من مواجهة المشكلة عندما يكتفون بصياغة المشكلة وكأنها حدّ بين موقفين: التطرّف والاعتدال. يتهربون عندما لا يضعون المشكلة في إطارها الصحيح، وهو يتعلّق بدور الدين في المجتمع. هل هو دور يتناول كل المجتمع أم هو دور فردي يتعلّق بجزء من المجتمع. لا خوف على الدين. الخوف على المجتمع. الموضوع مجتمعي لا ديني. المجتمع هو الذي يعاني لا الدين. يعاني المجتمع لأن المزاج الديني هو كل المجتمع. لا يخرج المرء من دينه عندما يصير الدين جزءاً من حياة الفرد لا كلها؛ عندما يقتصر الامر على الإيمان والطقوس المتعلقة به (الصلاة، والصوم، والجمعة، الخ…) وفي الوقت نفسه ينخرط الفرد في الحياة العامة، وفي السياسة بغضّ النظر عن متطلبات الدين السياسي. بكلمة مختصرة، عندما يتلاشى الدين السياسي في مجتمعنا. ولا لزوم عندها لدعوة الفصل بين الدين والسياسة. لا مكان للدين في الحياة العامة. الحياة العامة هي السياسة وحسب؛ هي مواجهة المشاكل التي تعانيها أمتنا في حياتها اليومية (من إشارات المرور الى الضرائب الى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية برمّتها).
لم يأت الدين لتنظيم حياة الناس، كل حياة الناس. فيه تعاليم تتعلّق ببعض الحياة. وهذه يمكن إعادة تفسيرها لتتلاءم مع متطلبات العيش في هذا العصر. لو كان الدين وصفة جاهزة كاملة لما كان هناك تفسير جديد كل بضع سنوات على مدى التاريخ.
آن الآوان لحصر الدين بالحياة الفردية، وتحديداً بالايمان وطقوسه. ما عدا ذلك هو شأن السياسة والتدبير. شأن يقرره الناس فيما بينهم بالسياسة والحوار والنقاش في الساحة العامة. في مجتمع مفتوح. هناك زيادات كثيرة أضيفت في كل مرحلة واعتبرت جزءاً من الدين. وهناك نصوص كثيرة في الكتاب المقدس يمكن إعادة تفسيرها، على أن يكون التفسير متروكاً للفرد حسب ضميره، أي إيمانه. ليس في الدين شريعة للناس. وما يُسمّى شريعة أمر مختلف عليه. الاختلاف يطال كل الآيات تقريباً. وسيكون إجحافاً وظلماً واستبداداً أن يأتي فريق ويقول هذه المجموعة من التفسيرات هي الشريعة وهي القانون. وهي ما يجب تطبيقه. الشريعة شرائع. وهي ليست قانوناً. هي خلفية ذهنية لا بد أن يتأثر بها كل فرد حين يتعاطى بالشأن العام. لا يتحوّل الفرد الى مواطن إلا عندما يكون لديه الحق والواجب بأن يفكّر في شؤون الحياة ومنها الشريعة (شريعات) ليختار ويتجاوز ما ورثه، ويصنع حياة جديدة. ما هو جديد ليس بدعة، وإذا كان كذلك فإن حق المواطن أن يبتدع بغضّ النظر عما يقوله الفقهاء، حتى فيما يتعلّق بالأحوال الشخصية. كل شيء عرضة للتجديد والابتداع. كل تفسير جديد مرحّب به على أن يبقى خلفية ذهنية لا للاتّباع بل للتجديد والابتداع.
ليس من حق مجموعة من الاختصاصيين ادعاء القول أن ما يقولونه هو ما أراده الله. لا نعرف هذه الإرادة إلا حسب تفسيراتنا الفردية، أي العقلية. الحقيقة المطلقة ليست ملك أحد من الناس؛ هي ملك الناس جميعاً، على اختلافاتهم واختلاف ظروفهم وهواجسهم الفكرية (العقلية). كل منا يملك حقيقة نسبية (جزئية) وحسب.
لا يخرج عن دينه من اعتبر الدين جزءاً من حياته. يخرج عن دينه من اعتبر الدين أو المذهب كل حياته.
الاستبداد هو أن يقول فريق من الناس هذا هو الدين وهو كل الحياة، وهو القانون والدستور. القانون والدستور يضعهما الناس. وسيكون طبيعياً أن يكون كل واحد منهم متأثراً بخلفيته الدينية، ولو سمّاها شريعة. الاستبداد هو أن تنزع من أيدي الناس وضع الدستور والقوانين وتسلّم ذلك للسلطة. وتكون النتيجة الفعلية لذلك هي توسّع صلاحيات السلطة وازدياد قمعها واستبدادها. عندما تحصر الدين في المجال الفردي فإنك تنقذه من السلطة وتحتفظ به ويصير هو صلتك مع الله. لا خير في إخراج الدين للحيّز العام؛ لا خير في السماح للسلطة بالسيطرة عليه.
المنافقون الذين يدّعون الاعتدال الديني هم الذين فعلوا ذلك وجعلوا الدين أداة بيد السلطة؛ هم الذيم مكّنوا السلطة من التحالف مع الدين بعد أن حوّلوا هذا الأخير الى أداة سياسية. تحالفت السلطة مع الدين السياسي. وكانت بحاجة لذلك كيلا يكون الاستبداد مجرداً ومستنداً الى القمع وحسب. فجاءه حليف يقدم له كل المبررات التي يُزعم أنها إلهية. لم يكن ينقص الطاغية شيء ليعلن نفسه إلهاً أو ممثلاً للإله. ذلك تيسّر له عندما وضع الدين في خدمته. شعار تطبيق الشريعة يضعها في خدمة الاستبداد. استبداد فكري، تسلّط على الحقائق. خلق حقيقة وهمية.
الاعتدال في الدين ليس الاختيار بين موقف ديني وآخر. هو ليس اختيارا بين مذهب وآخر. هذا الاعتدال يعيد صاحبه الى حيث بدأ. لا يعالج المشكلة وينتهي لصالح حكم الاستبداد. المشكلة الحقيقية هي وضع الدين في مكانه الحقيقي؛ وذلك غير ممكن من دون تهميش الدين، وإخراجه من الحياة العامة. بالتالي إزالة الإسلام السياسي، وحصر الدين في المجال الشخصي الفردي؛ الدين كله لا جزءا منه. الخطر الأكبر على المسلمين مادياً وذهنياً هو اعتبار الدين عاملاً سياسياً، ثم الاختيار بين مواقف يعتبر بعضها أقل تطرفاً. كل إسلام سياسي هو متطرّف. كل إسلام سياسي يخلط بين المجالات هو تعسّف، ويضع الدين في خدمة السلطة ليجعلها مستبدة، حتى ولو لم تكن هكذا في البداية. احترام الدين يقضي بتهميشه، وبأن يكون مجاله في الحياة محصوراً. احترام الإنسان يكون في السياسة، وبأن يستعمل كل الأدوات الفكرية عنده، ومنها الدين. يكون الدين للعبادة، لمن أراد. ويكون للمجالات الأخرى من النشاط البشري أنماطها الفكرية المستمدة من التجربة العقلية. المجتمعات الإسلامية جميعها تهدد نفسها، وتدين نفسها، وتمارس العنصرية المضادة على نفسها، وتتأخر عن ركب الحضارة الإنسانية، وذلك عندما تعتبر أن الدين هو مجمل حياتها. هذا الاعتبار يحوّل الإنسان الى اعتقاد سياسي والى اختلافات تنتهي بحروب أهلية. مع الإيمان الفردي لا مكان للحروب الأهلية التي نراها الآن. هذه الحروب هي حصيلة التحالف بين السلطة السياسية والدين السياسي، حتى ولو لم يكن التحالف معلناً. هو تحالف مضطرّ أحيانا لعقد اتفاقات سرية وتحالفات احتيالية. تحالف يحوّل المتدينين الى محتالين في خدمة السلطة، سلطة الاستبداد.
الفرق بين الدين الفردي والدين السياسي (الجماعي) هو أن الأوّل أداة للتحرّر واستخدام الضمير في السياسة، أي الحوار والنقاش العام في الساحة العامة، وفي الميدان. الدين السياسي يحيل أتباعه الى الطائفية، ويجعلهم أتباع فريق من دون آخر. يحصر النقاش في المجال العام. يجعل السياسة أسيرة لعبة الطوائف، ويلغي الإيمان الفردي. ويؤدي الى إعلاء شأن الطائفة. يجعل الفرد عضواً في طائفة. ينزع عن الفرد إمكانية أن يصير مواطناً في دولة. يلغي إمكانية التحرر. يلغي إمكانية نشؤ الدولة. الدولة تتشكّل من أفراد. الطوائف تأكل من الدولة. تلغيها بعد أن تقضمها بكل شراهة مادية ومعنوية. في الطائفية ملاذ الاستبداد والفساد. في الفردانية المطلقة الإمكانية الوحيدة للتحرر من الاستبداد والفساد؛ إذ هنا يتصرّف الفرد حسب ضميره. ويكون تصرفه بالضرورة أخلاقياً. لا أخلاق في الدين السياسي. هناك فساد وحسب. الأخلاق هي في الدين الفردي وحده. بالضرورة كل طائفة تحمي فاسديها. بالضرورة المواطن يحمي الدولة والنظام من الفساد. عندما تحولت بلادنا الى الطائفية، معنى التحوّل هو احتماء الفساد بالطائفة؛ هذه شبكة علاقات أولويتها ليس الله والإيمان به بل الفساد وإلغاء الفرد. الفساد سبب آخر للاستبداد. تضطر الطوائف الى الإمساك بالسلطة كي تحمي فاسديها. لا اعتدال في ذلك. محاربة الفساد عندنا فاسدة. هي الأرض الصالحة لتوليد الفساد.
أخيراً، ليست المسألة فصل الدين عن الدولة. هما مفصولان كمؤسسات. المسألة هي في فصل الدين عن المجتمع، ومنع الدين السياسي. وعزل الدين في مكانه الطبيعي كجزء من الحياة البشرية. فصل الدين عن الدولة لا يجدي شيئاً. هو نظام الملل العثماني. هو الاعتراف بالدين السياسي واعتراف بالطائفية. ذلك لا يمنع من نشوء مذاهب وطوائف، شرط أن يكون الانتماء إليها فردياً واختيارياً، وأن يترك الخيار السياسي فيها للأفراد. ولا يكون للمذاهب علاقة مع السياسة. وهذا يعني تطوراً في المجتمع لم نصل إليه بعد. هذا التطوّر من مرحلة نكون فيها قطعاناً الى مرحلة نكون فيها أفراداً. القطيع بالتعريف يحتاج الى زعيم. الفرد بالتعريف لا يحتاج الى زعيم بل الزعيم يحتاج للفرد. في هذه الحالة الأخيرة يكون الانتماء عند الأفراد والزعماء للدولة. يكون الزعيم اشتقاقا من الدولة، ويكون إلتزام الأفراد بالدولة، وتكون الدولة مزروعة في ضمير كل واحد منا. الشرط هو أن تكون الدولة شرطاً لما عداها، ولا يكون أي تشكيل شرطاً عليها. علاقة الفرد بالدولة تقرر كل شيء آخر، بما في ذلك ما يدّعي الدين السياسي أنه مجال له. عند ذلك يطلّ الفرد على الدين من الدولة، ولا يطلّ على الدولة من الدين. وتكون السياسة مجالا للدولة وحدها.
(يتبع)
تنشر بالتزامن مع مدونة الفضل شلق